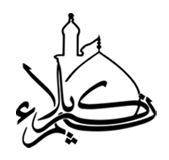هويّتُنا الثقافيةُ في مواجهةِ الطّوفان..

تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»
بقلم :حسين فرحان
اشترك في قناة «وكالة نسيم كربلاء» على تليجرام
“إنّنا نشهدُ في هذه الأيامِ تزايُدَ الحملاتِ على شبابِنا لطمسِ هويّتِهم الثقافيةِ والوطنيةِ والدينية”..
كلماتٌ تضمّنتْها إحدى خُطَبِ الجمعةِ التي أُلقيَتْ في الصحنِ الحُسيني الشريف..
كلماتٌ تُذكِّرُ الأُمّةَ بمسؤولياتِها تجاهَ واقعٍ مريرٍ يستهدفُ به الأعداء كُلَّ مقوماتِ هذه الهوية، وقد لوحِظَ أنّ الخُطبةَ قد أكّدتْ في مضامينِها على شريحةِ الشباب، لما لهذه الشريحةِ من قيمةٍ عظيمةٍ في المُجتمعِ وما يُمكِنُ أنْ يكونَ الحالُ عليه فيما لو انهارتْ فيه هذه الهويّةُ بمفاصلِها الثقافيةِ والوطنيةِ والدينية..
وللمُتابعِ أنْ يُلاحِظَ أيضًا ذلك التعبيرَ الدقيقَ الذي جاءَ في هذا النصِّ وهو عبارة: “تزايُد الحملات” ليفهمَ من ذلك حالةَ الاستمرارِ لمُحاولاتِ طمسِ الهويّةِ وليسَ الحديث عن أمرٍ جديد، فتاريخُ هذا الاستهدافِ والأساليبُ التي اُستُخدِمتْ فيه كثيرةٌ وطرقُ التصدّي له كانتْ قد اختلفتْ كذلك من مُجتمعٍ لآخر بحسبِ شِدّةِ الهجمةِ من جهةٍ ومدى قوةِ إيمانِ المُجتمعاتِ وتمسُّكِها بهويّتِها من جِهةٍ أُخرى، لذلك نجدُ في عبارة: “تزايُد الحملات” ما يدفعُنا لقراءةٍ تاريخيةٍ يُمكِنُ أنْ نُلاحِظَ من خِلالِها -ولو بأمثلةٍ مُحدِّدةٍ- مدى خطورةِ مثلِ هذه الحملاتِ وتأثيرِها على مُجتمعاتِنا بكُلِّ فئاتِها وبصورةٍ عامةٍ ولنعرف ما ينبغي علينا فعله.
فمن الشواهدِ التاريخيةِ -مثلًا- قيامُ لويس التاسع الملك الفرنسي –بعد فشلِ حملتهِ الصليبيةِ السابعةِ سنة 684 هجري- بكتابةِ وصيتِه التي يعدُّها البعضُ دستورًا وميثاقًا مُقدّسًا وطريقةً مُثلى لاحتلالِ الشعوبِ الإسلاميةِ على نحوٍ خاص، فقد أُعلنَ فيها صراحةً أنَّ المعنيَّ بها هو هذا الدينُ وهذه الشعوب، ووردتْ بهذا الشكل:
“أوصي بني قومي ألّا يُقاتلوا (الكُفّار) – يقصدُ بذلك المُسلمين- في ميادينِ القتالِ المفتوحة، فنيرانُهم حاميةٌ ولا يستطيعُ أحدٌ أنْ يقومَ لهم، والسِرُّ وراءَ قوتِهم وصمودِهم يرجعُ إلى تمسُّكِهم بعقيدتِهم ودينِهم، وأنّكم لنْ تنتصروا عليهم إلا إذا قطعتُم العلائقَ بينَهم وبينَ مصدرِ قوّتِهم، وصرفتموهم عن عقيدتِهم ودينِهم”..
هذا ما كتبَه لويس الفرنسي في وصيّته..
لذلك ورغمَ اعتمادِ الأعداءِ على القوّةِ العسكريةِ في كثيرٍ من غزواتِهم إلا أنَّ بنودَ وصيّةِ هذا الملك لم تفارقْ ثقافتَهم في مواردَ أُخرى وأزمنةٍ أخرى وجدوا فيها عدمَ جدوى المواجهةِ العسكرية، فالحربُ على طريقةِ لويس تؤتي ثمارَها وربما بشكلٍ أفضل خاصّةً مع استخدامِ أدواتٍ ناعمةٍ تتخذُ مظهرَ الحضارةِ والتقدُّمِ والتكنولوجيا، وتتزيّنُ بالمُصطلحاتِ الغربيةِ التي يحلو للبعضِ تكرارُها استعراضًا للمهاراتِ الببغاوية في ترديدِ ما يُقالُ دونَ إدراكٍ لما يُرادُ من إشباعِ الأدمغةِ بها..
ولعلَّ واحدةً من هذه الأساليبِ أنْ تحتضنَ البلادَ الإسلاميةَ هي المدارسُ التبشيريةُ أو فروع الجامعاتِ الغربيةِ بلا قيودٍ؛ ليقضيَ فيها الطلبةُ سنواتٍ من الدراسةِ مشوبةً بطباعٍ لا تمتُّ لهويّتهم وخصوصيتهم بصلة.. ففي مصرَ وأثناءِ الاحتلالِ البريطاني لها كانَ الحاكمُ العسكري (كرومر) يؤكِّدُ على فتحِ مدارسَ تغريبيةٍ بكُلِّ ما تحملُه من قيَمٍ دخيلةٍ تتغلغلُ إلى المجتمعِ عبرَ الشبابِ بدعوى تلقّي العلومِ الحديثةِ ومواكبةِ الغرب..
حتى ظاهرة الاستشراقِ التي أخرجتْ للعالمِ كُتُبًا ومجلداتٍ وبحوثًا حولَ الشرقِ وعاداتِه وتقاليدِه ومُعتقداتِه، لم يكنِ الهدفُ منها التعريفَ بهذه الثقافةِ بطريقةٍ تُراعي الأمانةَ العلميةَ المُجرّدةَ بل كانتْ –ومثلما يعتقدُ البعضُ من المُثقّفين- وسيلةً من وسائلِ التحصينِ الفكري للعقلِ الغربي تجاهَ الفِكرِ الإسلامي وتزويدِه بكُلِّ أسلحةِ المواجهةِ الفكريةِ وحمايتِه من أنْ يتأثّرَ بأيّ شكلٍ من الأشكالِ بهذا الفِكرِ فيما لو دخلَ غازيًا أو حتى سائحاً في هذه البلاد..
فتلك حصانةٌ فكريةٌ قدّمَها الاستشراقُ لحمايةِ مُجتمعاتِ الغربِ وذلك لوجود حالاتٍ اعتنقتْ فيها بعضُ الجيوشِ الإسلامَ وعادتْ به إلى ديارها، مثلما حدثَ في بعضِ الحروبِ الصليبيةِ أو حروبِ التتار والمغول التي كسرتْ قاعدةَ تأثُّرِ المغلوبِ بالغالبِ لتجعلَ من الغالبِ مُتأثِّرًا بثقافةِ المغلوب.
من الشواهدِ التاريخيةِ الأُخرى على شِدّةِ الحذرِ الغربي والخوفِ من احتفاظِ الشعوبِ الإسلاميةِ بهويّتِها الثقافيةِ ما جاءَ في وثيقةٍ لوزيرِ المُستعمراتِ البريطانيةِ (أورمس غو) الصادرةِ سنةَ 1938م، والمحفوظةِ بالمركزِ العام للوثائقِ في لندن: “إنَّ الحربَ علّمَتْنا أنّ الوحدةَ الإسلاميةَ هي الخطرُ الأعظمُ الذي ينبغي على الإمبراطوريةِ أنْ تحذره وتُحاربَه، وليستْ انكلترا وحدها هي التي تلتزمُ بذلك بل فرنسا أيضًا…”.
ويقولُ (نيكسون) وهو أحدُ رؤساءِ الولاياتِ المُتحدةِ سابقًا: “إنّنا لا نخشى الضربةَ النوويةَ، ولكن نخشى الإسلامَ والحربَ العقائديةَ التي قد تقضي على الهويةِ الذاتيةِ للغرب”
وقال أيضًا: “إنَّ العالمَ الإسلامي يُشكِّلُ واحدًا من أكبرِ التحدّياتِ السياسيةِ للولاياتِ المُتحدةِ الأمريكيةِ الخارجيةِ في القرنِ الحادي والعشرين”..
وقال في إحدى مُذكّراته: “ليسَ أمامَنا بالنسبةِ للمُسلمين إلا أحدَ حلّين: الأول: تقتيلُهم والقضاءُ عليهم، والثاني: تذويبُهم في المُجتمعاتِ الأُخرى المدنيةِ والعلمانية”.
ويقول “غلادسون” رئيسُ وزراءِ بريطانيا سابقًا: “ما دامَ هذا القرآنُ موجودًا في أيدي المُسلمين فلنْ تستطيعَ أوربا السيطرةَ على الشرق”.
ويقولُ (مورو بيرجر) في كتابِه (العالم العربي المعاصر): “إنَّ الخوفَ من العربِ واهتمامَنا بالأُمّةِ العربيةِ ليس ناتجًا عن وجودِ البترولِ بغزارةٍ عندَ العرب، إنَّ الإسلامَ يُفزِعُنا عندَما نراه ينتشرُ بيُسرٍ في العالمِ شرقِه وغربِه”.
أمّا الذين يُركِّزون على (حربِ الأفكار)، بل ويعدّونها من الحروبِ المُهِمّةِ التي ينبغي استخدامُها لطمسِ الهويةِ الثقافيةِ للمُجتمعاتِ الإسلاميةِ؛ فمنهم على سبيلِ المثال (زينو باران) الباحثةُ التي تعملُ في موقعِ مركزِ (نيكسون) الذي صدرَ عنه تقريرٌ بعنوان: (القتالُ في حربِ الأفكار)، واعتمدَ عليه –بشِدّة- دونالد رامسفيلد، وكانَ يُصرِّحُ بأهميّةِ غزوِ العالمِ الإسلامي ثقافيًا..
ومنهم أيضًا (فيليب فونداسي) رئيسُ المكتبِ الخامس الفرنسي لمصلحةِ التجسُّسِ الفرنسيةِ الذي قالَ في مُقدِّمةِ كتابِه: (الاستعمارُ الفرنسي في أفريقيا السوداء): “إنَّ هذا الإسلامَ يؤلِّفُ حاجزًا أمامَ مدنيتِنا المبنيّةِ كُلِّها من مؤثِّراتٍ مسيحيةٍ ومن ماديّةٍ ديكارتية، فإنَّ الإسلامَ يُهدِّدُ ثقافتَنا في أفريقيا السوداء، وعلى الرّغمِ منْ أنَّ بعضَ النفوسِ المُتسامِحةِ تميلُ بطبيعتِها وعن رضا منها إلى عدمِ تقديرِ هذا الخطرِ (الإسلام) حقَّ قدرِه، فإنّه يبدو في الظروفِ الحاليةِ للتطوّرِ الاجتماعي والسياسي لعالمِ البشر، إنّه من الضروري لفرنسا أنْ تُقاوِمَ الإسلامَ في هذا العالم، أو تُحاوِلَ –على الأقلِّ- حصْرَ انتشارِه وأنْ يُعاملَ وفقَ أضيقِ مبادئ الحياةِ الدّينية.
هذه باختصارٍ شديدٍ أمثلةٌ وشواهدُ لرؤيةِ الآخر لهويّتِنا الثقافيةِ التي مِنْ أهمِّ ركائزِها الدّينُ الإسلامي الحنيف، وهذه هي انطباعاتُهم السائدةُ ومخاوفُهم وهذا جُزءٌ ممّا أسّسوا له في سبيلِ محوِ هذه الهوية.
فهل سنكونُ بقدرِ مسؤوليةِ المواجهةِ، أم أنّنا سنتقاعسُ عن أداءِ واجبِنا تجاه أبنائنا وبناتنا؟
هل سنُدرِكُ أهميّةَ هذه المواجهة؟
لربما سيتصوّرُ البعضُ أنّنا حينَ نعترضُ على مظاهرَ مُخِلّةٍ بالذوقِ العام تطرُّفًا.. وربما نُتّهَمُ بالتخلُّفِ وعدمِ مواكبةِ التطوّرِ خصوصًا مع انغماسِ أغلبِ المُجتمعاتِ الإسلاميةِ في وحلِ الهزيمةِ الفكريةِ واستسلامِها لمُتطلّباتِ العولمةِ وانشغالِها بالفقرِ والأزماتِ والضرائبِ والقمعِ السياسي، لكنّنا وبأعلى مُستوياتِ الوعي ينبغي أنْ نُحافِظَ على هويّتِنا الثقافيةِ في بلدِنا، وأنْ لا نقفَ مكتوفي الأيدي أمامَ مُحاولاتٍ شيطانيةٍ تتبنّاها جهاتٌ مشبوهةٌ لنشرِ ثقافةِ الانحلالِ والشذوذِ والتمرُّدِ على المُقدّساتِ والقيَمِ بإقامةِ حفلاتٍ ومهرجاناتٍ لا تستقطبُ إلا من ذابوا في عالمٍ غيرِ عالمِهم واعتنقوا فكرًا هجينًا لا هويةَ له سوى عنوانٍ باهتٍ يُدعى القريةَ الصغيرةَ أو القريةَ الكونيةَ (الكوسموبوليتية) أو الكوكبيةَ أو العولمةَ، وما أكثرَ صفاتها وعناوينها وأسماءها!
سمِّها ما شئتَ؛ فالنتيجةُ هي السقوطُ الحضاري المُدوّي حيثُ تتداعى عليكم الأُمَمُ من كُلِّ أُفُقٍ مثلما تتداعى الأكلة على قصعتها..
“إنّنا نعتزُّ بهويّتِنا واستقلالِنا وسيادتِنا”