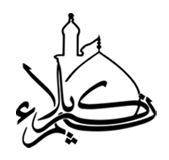مقال جديد للسيد محمد باقر السيستاني.. واقعة الغدير ودلالات المشهد الجماهيري العام

إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد اختار إلقاء خطبة الغدير التي خصّها بإثبات الولاء للإمام (عليه السلام) على المسلمين في مشهد جماهيري عام يحضره عامة المسلمين.
بقلم : آية الله السيد محمد باقر السيستاني
وهذا ينبّه على أنّ نوع مضمون الخطاب كان يقتضي إلقاءه على المجتمع العام، وهو يلائم النظر إلى إثبات الولاء الخاص (السياسي) للإمام عليّ (عليه السلام)؛ لأنّ هذا الولاء قضية موجهة لعامة الناس طبعاً، بينما لو أريد بالخطبة بيان الولاء الثابت بين آحاد المسلمين من جهة جامع الإسلام، فإنّ ذلك لم يكن يقتضي تعريف الإمام (عليه السلام) لعامة المسلمين، فهذا الولاء بينه وبين عامة المسلمين ثابت بثبوته بين آحاد المسلمين جميعاً.
بيان ذلك: أنّه ليس هناك مِن شك في أنّ الاهتمام بنوع الحضور المخاطبين بالكلام وعددهم يأتي مناسباً مع طبيعة مضمون الخطاب، وخطورته والاهتمام بإيصاله لأجل ذلك إلى عدد أكبر، بشكل مباشر وغير مباشر.
وهذا المعنى أمر بديهي بالالتفات إلى أنّه متى كان المتكلم بليغاً وحكيماً، فهو يراعي التناسب بين مضمون الكلام وبين المشهد الذي يلقي الكلام فيه فيختار المشهد المناسب للكلام الذي يريد إلقاءه، والكلام المناسب للمشهد الذي يخاطبه بالكلام، فيتكلّم في كل مقام بما يناسبه.
وفي ضوء ذلك إذا لاحظنا أقوال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّها كانت على أقسام:
الأوّل: ما خاطب (صلى الله عليه وآله وسلم) به شخصاً واحداً بالأصالة وإن سمعه الآخرون: إمّا جواباً منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على سؤال سأله منه الشخص الخاص، أو ابتداء منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكلام.
الثاني: ما خاطب (صلى الله عليه وآله وسلم) به الجماعة الذين يحضرونه (صلى الله عليه وآله وسلم) عادة في المجلس الذي يجلس فيه.
الثالث: ما خاطب (صلى الله عليه وآله وسلم) به الجماعة الذين كانوا يحضرونه عادة عند إتيانه بالصلوات الفرائض، فإنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي جماعة، فيخاطب (صلى الله عليه وآله وسلم) الحضور.
الرابع: ما خاطب (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه الناس بعد استدعائهم للاجتماع في موطنه بالمدينة، وكان طلبه اجتماع الناس يكون عادة بدعوتهم للصلاة جماعة، فيكون الحضور حينئذٍ أزيد ممن يحضر الجماعة عادة.
الخامس: ما خاطب به الناس في خطبة الجمعة في موطنه بالمدينة، والحضور في صلاة الجمعة أضعاف من يحضر للجماعة عادة؛ لأنّ صلاة الجمعة ليست على حدّ غيرها من الصلوات الفرائض؛ لأنّها لن تصحّ إلا جماعة؛ ولأنّه لا يجوز تعدد صلوات الجماعة إلا مع بُعد إحداهما عن الأخرى بمسافة كبيرة، كما هو معروف، وعليه فكان يحضرها المسلمون الذين كانوا في أطراف المدينة أيضاً.
السادس: ما خاطب به جمهور المسلمين، وكان ذلك بطبيعة الحال يتوقف على أن يكون الاجتماع في الحج أو من توابعه، حيث يتسع الحضور ليشمل المسلمين من البلاد المختلفة.
السابع: ما اهتم (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه بشكل خاص بمخاطبة الغائبين أيضاً، من خلال توصية الحاضرين بتبليغ الغائبين بما يذكره لهم.
وهذه الأقسام ذات المستويات المتعددة تتعلق بأمور:
الأوّل: أن يكون الموضوع خاصاً يخصّ فرداً أو يعم جماعة أو قوماً أو يكون أمراً عاماً.
الثاني: أن يكون الموضوع عاماً في نفسه يتعلق بعامة الناس، لكن ينبغي لكل فردٍ أن يبحث عنه ويسعى إلى الاطلاع عليه مثل تفاصيل الأحكام الشرعية، فإنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يبينها في خطبه، بل ينيط الاطّلاع عليها بسعي كل امرئ مسلم إلى ذلك بنفسه ولو كان بالسؤال من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومما يوضح ذلك أنّ القبائل العربية التي كانت تفد في السنة التاسعة والعاشرة للهجرة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسأل عن الدين كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يذكر لها إلا أصول الفرائض مثل وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج والخمس، ولم يكن يزيد كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم على سطر أو سطرين، وكانت تعلم أنّ تفاصيل هذه الفرائض وسائر تعاليم الدين منوطة بسعيهم إلى ذلك.
وقد جاء في القرآن الكريم تشويق المسلمين الداخلين في الإسلام من البلاد المختلفة بإرسال وفود إلى المدينة لأجل الاطلاع على تعاليم الدين، قال تعالى: [وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ]([1]).
كما أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبه في حجة الوداع ـــ كالتي ألقاها في عرفات وفي منى ـــ لم يكن يذكر تفاصيل الأحكام الشرعية، بل ينيط ذلك بتعلم القرآن الكريم، أو السؤال مِن المتعلمين من المسلمين، وإنّما كان يركز على مفاصل مهمة، أو أحكام معينة يجد حاجة خاصة للتبليغ العام فيها.
وكذلك القرآن الكريم نفسه لا يهتم بذكر كثير من التفاصيل موكلاً إياها إلى السنة، ويقتصر على طرح أمور معينة يستوجب ذكرها، وهذا بالرغم من تكرار كثير من المعاني فيها تأكيداً مثل أصول الدين وفرائضه ومعاني العدل والاحسان.
الثالث: أن يكون الموضوع مما يتعلق بالشأن العام، والفرق بين الشأن العام والحكم العام أنّ الحكم العام هو كل وظيفة مشتركة بين الناس، ولو كان حكماً فردياً مثل وجوب الصلاة بتفاصيلها، وحرمة غيبة الآخرين والتجسس عليهم وسوء الظن بهم وغير ذلك. وأمّا الشأن العام فهو من قبيل تعيين أولياء الأمور.
على أنّ الشأن العام يختلف مقتضاه في كيفية بيانه، فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلاً كان يعين عند الخروج من المدينة مَن يلي الأمر فيها؛ كي يكون هناك قوة مركزية في المدينة تحول دون حدوث خلأ فيها وتقي من الفتنة والنزاع فيها أو أي حادث اجتماعي أو سياسي مهم آخر، ولكنه لم يكن يحتاج إلى عقد اجتماع عام في المدينة، بل يبين ذلك على وجه اعتيادي.
وعلى ضوء هذه المقدمة يظهر أنّه كان من الممكن للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤجل بيان الولاء الثابت للإمام عليّ (عليه السلام) على المسلمين إلى حين الوصول إلى المدينة فيذكره لبعض أصحابه في مجلسه، أو بعد صلاة الجماعة لمن يحضرها بشكل اعتيادي، أو يدعو الناس إلى الصلاة جماعة حتى يحضر عدد أكثر، أو يبينه في يوم الجمعة عندما يجتمع الناس كلهم ممن يكون في المدينة أو أطرافها.
كما كان يمكن له (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبينه في سفره هذا ولكن على نحو محدود؛ إذ كان المسلمون معه ـــ وهم عشرات الآلاف ـــ متفرقين في الطريق، شأن كل عدد هائل من المسافرين يكونون في الطريق إلى مقصد مشترك، فيكون لكل جماعة أو أسرة خيمتهم، وينتشرون في مساحة واسعة، فيذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك مثلاً لبعض أصحابه ممن هو قريب عليه في مكانه، أو يدعو من يعتني بإسماعه إياه ـــ لمناسبة خاصة مثل معرفته منه إعراضه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـــ فيذكر ذلك له، أو يذكره لمن صلى معه جماعة بعد الصلاة.
لكنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفعل ذلك، بل اهتم بالإبلاغ العام للمسلمين به بملاحظة ما يأتي:
أوّلا: أنه اختار وجوده (صلى الله عليه وآله وسلم) في حضور جماهيري من توابع الحج، والحج وتوابعه أكبر اجتماع جماهيري طبيعي ومتنوع للمسلمين من حيث الكم والكيف.
والمراد بالكم: العدد فقد ذكر أنّه قد حضر معه إلى الحج عشرات الآلاف مِن المسلمين في أوّل حج له (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد إسلام الجزيرة العربية كلها تقريباً بعد وفود العشائر في تلك السنة وهي السنة العاشرة للهجرة، وقيل أنّه بلغ عددهم مائة ألف أو يزيد، وهذا عدد لم يكن يجتمع في أكبر اجتماع للمسلمين في المدينة ـــ وهو ما كان يتفق في صلاة الجمعة ــــ.
كما أنّ المراد من حيث الكيف: تنوّع الحضور مِن البلاد المختلفة، فالجمهور الذي يجتمعون في مدينة ما مهما كثروا فإنّهم يكونون من أهل تلك المدينة، لكن المجتمعون في الحج وتوابعه هم من أهل مدن وقرى مختلفة حيث يحضر الحج جمع معتد به أو غفير، فلا يقتصر الحضور على مدينة واحدة.
ثانياً: أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتنى بجمع كل الجماهير المشاركة في المسير، وهم عشرات الآلاف وهم منتشرون في مساحة واسعة، كلّ يكون في مكانه وخيمته، رغم العناء في ذلك عليه وعليهم، لما فيه من اقتضاء خروج الناس من خيمهم ومحاملهم إلى الوادي، واجتماعهم جميعاً وهم بهذا العدد الكبير وهو ما يستدعي الانتظار، وضرورة اقتراب بعضهم من بعض أو تلاصقهم حتى يسمعون صوته (صلى الله عليه وآله وسلم) جميعاً، وكل ذلك في حر شديد موصوف.
ولأجل تحفيزه (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم جميعاً إلى الحضور نادى (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة جامعة، وهذا النداء ينبّه الناس على أنَّ هناك عناية خاصة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بحضورهم جميعاً، وأنّ له رسالة مهمة يريد استماعهم إياها مباشرة.
ولو أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) شاء لخطب في مَن حوله ومَن قد يحضر ممن يبلغه ذلك قبل انتهاء الخطبة، وهم يبلّغون الآخرين طبعاً؛ لأنّ خطبته (صلى الله عليه وآله وسلم) على أيّ حال حدثٌ جديد يرغب الناس في نقله وتداوله وهم مقترنون في السفر الذي يكثر فيه الحديث والاجتماع، لكنه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرص على أن يسمع الجميع كلامه من غير استثناء، وبشكل مباشر من دون وسيط.
ثالثاً: أنّه اهتم بأن يُرِي الإمام عليّ (عليه السلام) لجميع الحضور، حيث جعل له مكان مرتفع، فصعد عليه وأخذ بيد الإمام (عليه السلام) ورفعه حتى يشهده الجميع في حاله هذا، علماً أنّ الكثير من الحضور ربما لم يكن يعرف الإمام علياً (عليه السلام) أصلاً؛ لأنّه وإن كان معروفاً لدى المهاجرين والأنصار، وقد يعرفه العديد ممن كان قد قاتل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن قَبل مِن جهة كونه فارساً بارزاً في الحرب، وسمع به آخرون لكن مع ذلك فإنّ ذلك لا يقتضي أنّ كلّ المسلمين بقبائلهم وعشائرهم كانوا يعرفونه رجالاً ونساء، فضلاً أن يميزوه بشخصه وملامحه، فقد دخل جلّ الجزيرة العربية في الإسلام بعد فتح مكة من خلال الوفود التي وفدت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و رجعت إلى بلادها، ولم تكن تعرف الإمام (عليه السلام)، فضلاً أن ترى له تلك المكانة المميزة.
إذن يُعلم من ذلك أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يُعرّف عامة المسلمين بعلي (عليه السلام)، وينقل الإمام علياً (عليه السلام) من شخصية خاصة يعرفها الأنصار والمهاجرين في المدينة وبعض آخر من المسلمين كفارسٍ مميز في حروب المسلمين مع الكفار واليهود إلى شخصية عامة يعرفها جمهور المسلمين باسمه وشخصه، ليكون ثاني شخصية عامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أوساط المسلمين من دون أن يكون لهما أي شخص ثالث يقترن بهما أو يليهما في ذلك؛ إذ لم يرقَ أحد بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى هذه الدرجة من التعريف العام به بين المسلمين.
لقد كانت خطبة الغدير وأسلوب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في إلقائها ـــ بوقوفه في مكان مرتفع يراه الجميع وأصحاب عليّ معه وبالأخذ بيده رافعاً إياه أمام الجمهور ـــ تريد أن تبيّن أنه (عليه السلام) ثالث الثلاثة في الولاء بعد الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن تُظهر اهتماماً بليغاً ومؤكَّداً منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يجعل علياً (عليه السلام) شخصية عامة معروفة ومرئية مقرونة بالله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أوساط المسلمين.
ومن المعلوم أنّ مثل هذا الأمر لا يلائم أن يكون مفاد خطبته هذه إعلام المسلمين بأنّ ما يربطهم بعلي ولاء الإيمان الثابت بين كل مؤمن وآخر. فهذا الولاء القائم بين آحاد المؤمنين كلهم يثبت لعلي (عليه السلام) كما يثبت لغيره، وقد يحسن توجيهه إلى مَن يعاديه (عليه السلام) خاصة وليس إلى جماهير المسلمين. وما الذي ينتفع به عامة المسلمين في البلاد ببيان ذلك لهم أصلاً!.
نعم، مثل هذا الأمر يلائمه أن يكون المراد هو عقد الولاء الخاص لعلي (عليه السلام)؛ لأنّه ولاء يجب أن يعرفه ويستحضره كل مؤمن، بعد أن اقتربت وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيابه عن الأمة، ليكون المسلم على بيّنة مِن الأمر متعهداً بالولاء لأهله، كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحاديث عديدة ـــ صححها المحدثون ـــ أكّد فيها على المسلمين في ألّا يبقى أحد منهم من دون إمام يواليه، حتى لا يكونوا هدفاً لكل صاحب هوى يريد أن يُدعى رأساً.
إذن نلاحظ أنّ في مخاطبة جماهير المسلمين بولاء الإمام (عليه السلام) عليهم دلالة أخرى على النظر إلى الولاء الخاص.
وقد يقول قائل: إنّ الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن الحجاج لم يكونوا إلا حجاج المدينة وما حولها؛ لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد خرج من مكة وبلغ ما يقرب من نصف المسافة بينها وبين المدينة، وقد فارقه ـــ بطبيعة الحال ـــ الحجاج الذين كانوا من أهل مكة، وكذا الذين كانت بلادهم في وجهة مختلفة كالطائف واليمن، وكذلك الذين كانت مواطنهم بين مكة والمدينة ولكن قبل غدير خم، فهؤلاء كلهم كانوا قد فارقوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين خطبته هذه.
والجواب: أنّ هذا القول خطأ، كما ينبه عليه على الإجمال أنّه إن صحَّ ما ذكر لم يكن هناك ما يوجب إيقاف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس في هذا المكان، لا سيما مع عدم وقوع غدير خم ـــ كما قيل ـــ في الطريق السائد بين مكة والمدينة، وإنّما يمر الطريق بينهما بالجحفة، وهو يبعد عن غدير خم بعض الشيء إلا أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) اتجه إلى غدير خم لأجل جمع الناس فيه، فما الذي دعاه إلى الاتجاه إلى هذا الغدير إذا كان الحجاج الذين معه يرافقونه بعد ذلك إلى حدود المدينة.
والواقع أنّ هناك العديد من قوافل الحجاج الذين كانت مقاصدهم في الطريق بين غدير خم وبين المدينة، وذلك أنّ بين مكة والمدينة عشر مراحل يبدو أنّها كانت عامرة تسكنها قبائل عربية.
قال المؤرخ اليعقوبي في تاريخه: (ومِن المدينة إلى مكة عشر مراحل عامرة آهلة: فأولها: ذو الحليفة ومنها يحرم الحاج إذا خرجوا من المدينة، وهي على أربعة أميال من المدينة، ومنها إلى الحفيرة وهي منازل بني فهر من قريش، وإلى ملل وهي في هذا الوقت منازل قوم من ولد جعفر بن أبي طالب، وإلى السيالة وبها قوم من ولد الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) وكان بها قوم من قريش وغيرهم، وإلى الروحاء وهي منازل مزينة، وإلى الرويثة وبها قوم من ولد عثمان بن عفان وغيرهم من العرب، وإلى العرج وهي أيضاً منازل مزينة، وإلى سقيا بني غفار وهي منازل بني كنانة، وإلى الأبواء وهي منازل أسلم، وإلى الجحفة وبها قوم من بني سليم وغدير خم من الجحفة على ميلين عادل عن الطريق، وإلى قديد وبها منازل خزاعة، وإلى عسفان، وإلى مر الظهران وهي منازل كنانة، وإلى مكة)([2]).
وبذلك نلاحظ أنّ المراحل بين الجحفة التي يقع غدير خم مسافة ميلين عنها وبين المدينة سبعة وكلها كانت مأهولة في عصره، ولا يبعد أنّ العديد منها كانت كذلك من قبل.
يضاف إلى ذلك أنّه ربما كانت هناك قبائل أخرى تسكن على بعد مناسب من هذه المراحل بحيث تعبرها أو تقترب منها في طريقها من مكة إلى مواطنها، وذلك مما يسهل الاطلاع عليه بمراجعة خريطة انتشار القبائل في الجزيرة العربية في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
على أنّنا نحتمل أنّ العديد من الناس ممن كانت مساكنهم دون غدير خم شايعوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بعض الطريق إكراماً له وتعلّقاً به، لا سيما وكان قد نعى نفسه لهم في بعض مواقفه خلال الحج، ومشايعة المرء صاحبه أمر كان شائعاً لمسافات غير قليلة، بل جاء الأثر باستحبابه وفضله.
نعم يتجه هنا سؤال آخر عن سرّ عدم إعلان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الولاء الخاص للإمام (عليه السلام) في مكة، وقد كان الحضور فيه أوسع، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ألقى خطباً فيها، فكان يمكنه أن يضمن بعضها ما جاء في خطبة الغدير.
اضغظ هنا للاطلاع عن هذا الاستفهام
والجواب عن هذا السؤال سيأتي في الإيضاح اللاحق.
([1] ) سورة التوبة: آية 122.
([2]) البلدان لليعقوبي: 1/152.